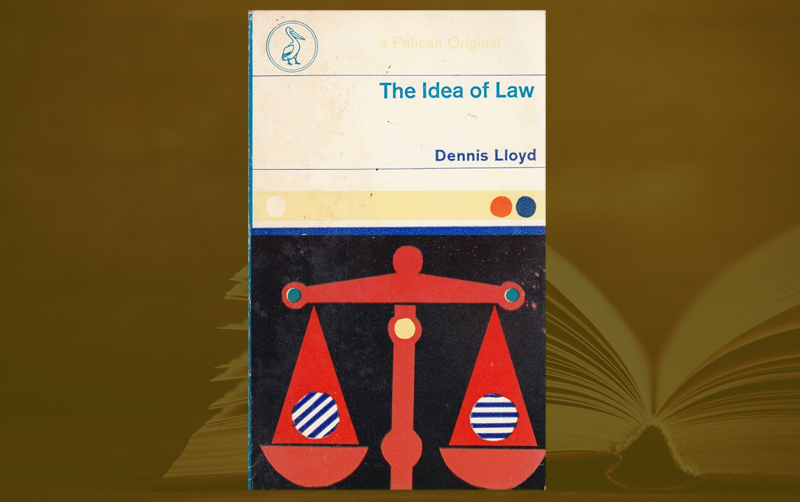كيف نشأ القانون؟ وما إشكالاته؟ وما علاقته بالأديان؟
الكتاب الذي بين أيدينا هو واحدٌ من الكتب التي استطاع مؤلفها إعطاء فكرة مستفيضة عن القانون، فقد رام “دينيس لويد” تجنّب الطريقة التقليدية المعتمدة في تدريس “المدخل لدراسة القانون”، مُعتمداً في ذلك على خبرته الطويلة في تعامله مع المادة القانونية، وإلمامه الجيّد بتاريخ الفكر الفلسفي والسياسي. والمؤلف هو خريج جامعتي لندن وكمبردج، امتهن المحاماة إلى جانب التدريس في جامعة لندن، وهو المهموم بقضايا القانون نظراً وممارسة، إذ صدرت له العديد من المؤلفات في القانون.
لم يكن اختيار الكتاب من أجل تقديمه للقارئ العربي عبثياً، أو فرضته جِدّة الكتاب أو شهرته، بل إنّ كلّ هذه الشروط تكاد تكون مفقودة بخصوص كتاب “فكرة القانون”، فهو كتاب صدر في ستينيات القرن المنصرم، ورغم اشتهاره في فترة سابقة في الوطن العربي بفعل الترجمة العربية التي أنجزتها سلسلة “عالم المعرفة” سنة 1981 (العدد 47)، فإنه اليوم يكاد يكون غير معروف إلا للقلة من الذين يشتغلون على المادة القانونية، مع العلم أنّ فكرته تهم كل أطياف المجتمع من مهنيين وطلبة ومدرسين ومواطنين، قياساً إلى طريقة مؤلفه في بسط إشكاليته، وفي اللغة البسيطة التي استخدمها من أجل الوصول إلى القارئ.
إذن، فنحن أمام محاولة لتقديم كتاب قيّم وثمين من الناحية العلمية، في ظلّ واقع يحتدّ فيه نقاش كبير حول غاية القانون، والجهة المخوّل لها تشريعه وتنفيذه، ومن أين يتحصل القانون على مشروعيته المجتمعية، وعلاقته بالأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية وغير الدينية، وسبل فرض احترامه، ومدى ارتباطه بفكرة العدالة والمساواة، كما أنّ هناك من يطرح مدى حاجة المجتمعات إليه، وغيرها من الأسئلة التي يطرحها المواطن راهناً، لا سيما في الظروف الانتقالية التي تعيشها العديد من الأقطار العربية والإسلاميّة. وهي الأسئلة التي نلفي محاولة جادّة للإجابة عنها في كتاب “فكرة القانون”. بيد أنّ الكتاب لا يفيدنا فقط في تلمّس بعض الإجابات، بل أيضاً في المقارنة بين أسئلة حاضرنا وأسئلة الكثير من الشعوب التي عمّرت الكرة الأرضية على امتداد قرون من الزمن، لأنّ الكاتب لا يقتصر في تناوله على منهج بعينه، وإنّما هو مُنفتِح على أهمّ العلوم التي تساعد في بسط فكرته، إذ نجده يَغرِف من علم الأنتروبولوجيا، والسوسيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، وعلم اجتماع الأديان، والدراسات المقارنة…وكلّ ذلك في قلب واحد يكاد لا يُشعِر القارئ بتعدُّد مناهِجه.
ولأنّ “دينيس لويد” حريصٌ على تبليغ فكرته إلى أكبر عدد من القراء، فإنّه لم يثقل كتابه بالإحالات المرجعية، أو ينقل إليهم أقوال الفلاسفة والعلماء بتعبيراتهم هم، بل إنّ الكتاب خالٍ من أية إحالات باستثناء الاقتراح الذي ختم به المؤلف كتابه، الذي تضمّن بعض الكتب المرجعية التي يمكن للقارئ العودة إليها إذا رغب في التفاصيل. ويكمن هذا الحرص أيضاً في اللغة حيث يُلحّ الكاتب على التبسيط والاستعانة بالأمثلة كي يفهم القارئ مراميه، إذ لا تكاد تمرّ فكرة دون أن يأتي “لويد” بمثال عليها سواء من الواقع الحي أو من التاريخ.
لا يتضمن الكتاب أفكاراً يمكن الاستفادة منها فحسب، ولكن هناك أيضاً غير المفكر فيه الذي يساعد على تلمّس تصور كاتب كبير عن المستقبل، وكيف أنّ العديد من القضايا التي كانت إلى عهد قريب غير ممكنة أصبحت اليوم من المسلّمات. وهذا الأمر نلمسه في الأفكار التي وردت في الكتاب بخصوص ما يثار من نقاش حول الإجهاض والقتل الرحيم والمِثلية والموت الرحيم، والمسائل التي يطرحها القانون الدولي، ودور التكتلات الدوليّة في فرض نوع من العدالة الدولية، وهي من الأمور التي استطاع المنتظم الدولي اليوم إيجاد بعض الحلول لها رغم التعثرات التي تصادف هذه المحاولة. وهناك قضايا أخرى استطاع الكاتب استشرافها بنوع من الذكاء المستقبلي، ساعده في ذلك إلمامه بالتاريخ والاجتماع.
ومن نافلة القول، إنّ كتباً من هذا النوع يصعب على المرء تلخيصها أو اختزالها في صفحات وجيزة، وكتاب “فكرة القانون” يؤكد هذا القول بشكل كبير، مادام صاحبه قد ضَمّنه تاريخاً طويلاً من النظر إلى القانون، وجعله خلاصة مطولة لعشرات الكتابات الفلسفية والدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولهذا، لا يمكن أن نزعم أنّ هذه القراءة تجعل المُطّلع عليها في غنى عن العودة إلى الكتاب، بل إنّ غايتها هي التحفيز على الاهتمام بفكرة القانون بالأسلوب الذي يطرحه دينيس لويد، وتجنب ما أمكن الطرق الكلاسيكة في تقديم القانون للمواطنين عموماً، ولمجتمع المعرفة القانونية بشكل خاص. وبالتالي فإنّ القراءة التي نقدّمها عن الكتاب لن تكون إلا تسليطاً للضوء على أهمّ الأفكار التي يبدو أنها تساعد على الإلمام بإشكاليّته، وتعطي فكرة وافية عن هيكله العام.
وينبغي التنويه أنّ كتاب “فكرة القانون” ليس من حسناته فقط أنّ محامياً وأستاذاً جامعياً قد كتبه، ولكن أيضاً لأنّ محامياً هو الذي نقله إلى اللغة العربية عن الإنجليزية، وأنّ محامياً ومترجماً مُعتمَداً هو الذي راجع عملية التعريب، وهذا ما أعطى الكتاب حيوية إضافية لم تؤثر فيها إلا بعض أخطاء الطباعة التي وردت في بعض الصفحات (وفي هذا السياق من المستحسن لو تمت إعادة طباعة الكتاب من جديد، لاسيما أنّ نسخ الطبعة الأولى لم يعد لها وجود في السوق).
يضمُّ الكتاب حوالي 300 صفحة من الحجم المتوسط، قسّمها المؤلف إلى 14 فصلاً، تساءل في أولاها الكاتب عمّا إذا كان القانون ضرورياً؟ ثم تطرّق في باقي الفصول إلى المواضيع التالية: القانون والقوة، القانون والأخلاق، القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية، الوضعية القانونية أو القانون الوضعي، القانون والعدل، الحريّة والقانون، القانون والسيادة والدولة، القانون والمجتمع، القانون والعرف، القضاء، التفكير التصوري في القانون، واختتم الدراسة بطرح بعض القضايا المستقبلية.
يرى المؤلِف في القانون إحدى المؤسسات الجوهرية في حياة الإنسان، بحيث إذا غاب القانون تستحيل الحياة إلى شيء مختلف جداً على ما هي عليه اليوم، وهو ما يحاول أن يبرزه من خلال فصول الكتاب. مع وعي لويد أنّ القانون وحده ليس كافياً لتحقيق التقدم المُبتغى، وإنما هناك علاقة وثيقة بين القانون والقواعد الخلقية. فمن خلال السؤال المحوري الذي يطرحه الكتاب حول ما إذا كان القانون ضرورياً، يحاول الكاتب التطرق إلى تاريخ من الشكّ في جدوى القانون في حياة الإنسان، مادام ليس هناك إجماع، على الأقل من الناحية الفكرية، على كون القانون شيئاً إيجابياً، بل هناك من يرى فيه شرّاً ينبغي تجنّبه. فالشعور بأنّ القانون ضرورة فطرية لم يكن يحظى بتشجيع الكثير من الفلاسفة من أفلاطون إلى ماركس ممّن دَعَوا بشكل أو بآخر إلى رفض القانون، وكذلك لعب العداء للقانون دوراً بارزاً في العديد من الأنظمة الدينية، وكان عنصراً حاسماً في أيديولوجية الكنيسة المسيحية في مرحلة تكوينها. كما أنّ هناك مجموعة من المتحمّسين في عصرنا للمذهب الفوضوي كحل لمشاكل الإنسان (يشير الكاتب هنا إلى التيار الذي خلقته أفكار السياسي الروسي “باكونين”).
لكن لويد عندما يطرح السؤال حول ضرورة القانون من عدمها فهو بذلك ـ كما يقول هو نفسه ـ لم يحاول ذكر حقيقة فيزيائية بسيطة فقط، وإنما يتعلق الأمر بعملية تقويم، وهذا يحتوي افتراضاً ضِمنياً عن هدف الإنسان وغايته، وعمّا هو خيرٌ له أو شرٌ له، وما يحتاج إليه للوصول إلى الأهداف (ص 13). وبعد استعراضه لآراء الفلاسفة والمفكرين حول مسألة الخير والشر المجبول عليها الإنسان (أفلاطون، هوبز، ماكيافللي، بودان…)، ومن خلال عرضه لعشرات الدراسات الأنتروبولوجية التي اهتمّت بمواقف بعض المجتمعات من القانون، يخلصُ الكاتب إلى القول إنّ أي مجتمع، بدائياً كان أو متطوراً، لا مفرّ له من وجود قواعد تحدد الشروط التي يستطيع الإنسان أن يُسيّر بها حياته في التزاوج والتجارة والفلاحة، قائلاً في هذا الصدد: “إنّ الفكرة القائلة إنّ المجتمع البشري يمكن أن يقوم على أساس أنّ بمقدور كل امرئ العمل بما يعتقده صواباً في حياته الخاصّة هي فكرة خَيالية لا تستحق الاعتبار، ذلك أنّ مجتمعاً كهذا لن يكون قَطعاً مجتمعاً بدون نظام، بل سيكون إلغاء ونفياً للمجتمع نفسه”. (ص 24)
غير أنّ سؤالاً آخر أكثر أهمية يبرز في هذا المستوى من النقاش، وهو: ألا ترتبط فكرة القانون بنظام القمع؟ وهنا أيضاً، وقبل أن يجيب لويد عن السؤال، فإنه راح يستعرض آراء المدارس الفلسفية والأنتروبولوجية والاجتماعية بخصوص هذا الموضوع، مُستنتجاً أنّ فكرة القانون تشمل ما هو أكثر من مسألة الخضوع، ولكنّ عنصر الطاعة والخضوع هو العنصر الحاسم. إذ يتضح أن القنّ يَعتبر سيده هو الشخص المطلوبة طاعته، وأنّ المواطن يعتبر ضابط الشرطة هو الشخص الواجبة طاعته، وكذلك القاضي. لكن من أين يأتي هذا الإحساس بواجب الخضوع؟ في هذا السياق يستحضر لويد المساهمات القيمة لعالِم الاجتماع الألماني “ماكس فيبر” الذي يُشير إلى الأنماط الثلاثة للمشروعية: الكاريزميّة والتقليدية والعقلانية. ومن هنا جاء تأكيد الكاتب على ضرورة السلطة الشرعية لقيام القانون بوظيفته في جميع المجتمعات. وإن كان جدلاً غير محسوم يظل ماثلاً أمام هذا التأكيد، ألا وهو علاقة القانون بالقوة وليس فقط بالسلطة، بمعنى آخر، هل تطبيق القانون تلزمه فقط سلطة شرعية حتى يكتسب نفاذه أم أنّ القوة قد تقوم أحياناً مقام الشرعية بصرف النظر عن كلّ القيم الأخلاقية؟ حيث يشير المؤلّف إلى السجال الممتد بين المدارس الفكرية حول العلاقة بين القانون والأخلاق، وإن كان في آخر المطاف يجنح إلى رأي علم النفس الذي يؤكّد أنّ “الناس ليسوا مخلوقات لطيفة ودودة، وأنهم يدافعون عن أنفسهم حين يُهاجَمون” إذ يجب أخذ تلك الرغبة الجبارة في الاعتداء بعين الاعتبار على أساس أنها صفة لصيقة بغرائزهم. ولهذا نجد أنّ فرويد ربط بين المجتمع المتحضر والنظام الاجتماعي القسري. وإن كان ينبغي لهذا القسر أن يتّسم بنوعٍ من الشرعية، لأنّه كلّما كان استخدام القوة أكثر تنظيماً وأكثر فعالية تراجع استخدام القوة. وفي هذا السياق يُورِد الكاتب العديد من الأمثلة من أجل التدليل على رأيه.
ومن مفارقات العلاقة بين القانون والقوّة أنّه بينما يُعتبَر القسر جزءاً لا يتجزّأ من النظام القانوني الفعّال، إلاّ أنّ ذلك لا يُبرّر الإصرار على أنّه يَترتّب على ذلك بالضرورة أن تلحق بكل حكم فردي في النظام القانوني نتائج جزائية، بل العكس هو الصحيح في نظر “لويد”، بدليل أنّ النظام الحديث يزداد ميلاً لتحديد الواجبات المهمة التي لا تحتاج إلى وضعِ نصوص جزائية مُلحقة بها. وفيما يتصل بالعلاقة بين القانون والدين، يعود الكاتب إلى التاريخ كي يسبر أغوار هذه العلاقة، حيث وَجد أنه في العصور السالفة كان القانون يتمتع بقداسةٍ تَنبع من مصدر إلهي أو سماوي، وكان القانون والأخلاق والدين مرتبطين ببعضهم بعضاً بشكل لا يمكن تجنّبه، وكانت هناك قوانين تُعتبَر إلهية المصدر. لكن ورغم أنّ الدين قام بدور أساسي في إضفاء المحتوى الجزائي على القانون، إلا أنّ تعارضاً كبيراً قد حصل بين القانون الوضعي والقانون المعتبَر إلهياً، وهو ما خلق سجالاً كبيراً في الماضي كما في الحاضر حوْل سُبل درء هذا التعارض، إذ لجأت الشعوب إلى الكتب السماوية من أجل حل هذه المشكلة، فالملوك يقترحون والله هو الذي يتصرف، ولهذا لا يمكن للقوانين البشرية أن تسمو فوق القوانين الإلهية، وإلا فإنّ الكتب الدينية ملأى بقصص العقوبات الزاجرة التي أوقعت على الملوك والشعوب الذين اجترؤوا على انتهاك شريعة الرّب (يستشهد الكاتب بما جاء في التوراة ص 46).
يشير دينيس لويد إلى أنّ احتمال تعارض القوانين البشرية ـ حتى لو صدرت عن حُكّام اختارهم الله ـ مع القوانين الإلهية أدى إلى إصابة الإنسان بأزمة أخلاقية، ولمناقشة هذه القضية يورد المؤلف ملاحظتين: مؤدى أولاهما أنّ فكرة القانون الإلهي لدى العبرانيين مثلاً نَجمت عن مساواة القانون بالأخلاق، حيث القانون الوحيد الحقيقي هو ذلك الذي جسّد أوامر الله، وهذا ما جعل الباب موارباً أمام الحكم الثيوقراطي، إذ لا مجال لأيّ قانون يَفتقد إلى مصدرِ ربّاني (ومثال ذلك ما شهدته الدولة اليهودية القديمة والعهود الأولى للحركة الكالفانية)، أمّا الملاحظة الثانية فهي ذات علاقة بسلطة تفسير النصوص التي يتمتع بها وسطاء بين الإنسان والله، إذ يتضح أنّ مدى التفسير الشخصي يظل غير محدود حيث يتنافس الإيمان والتعصب لفرض سيطرتهما على أتباعهما. كما يستحضر الكاتب التجربة اليونانية التي ربطت بين الرؤية الإلهية والقانون، بيد أنّ الفكر اليوناني كان يتجه نحو الاعتراف بأنّ القانون البشري، سواء استقى مصدره أو قِسماً منه من مصدر إلهي أو لم يفعل، كان يتمتع بمكانة مستقلة في المجتمع البشري، وإلا كان قد اتّخذ طابعاً مقدّساً. (يتضمن الكتاب محاورة سقراط وكريتو حول مسألة القانون أثناء خضوع الأول للمحاكمة).
أمّا في ما يخص العلاقة المفترضة بين القانون والأخلاق، فإنّ الأمر يتضمن العديد من المفارقات على الرغم من انطلاقهما من مبدأ متماثل، فمثلاً قد يعاقِب القانون على الفساد الجنسي في بعض الأحيان، لكنه يَمتنِع عن المساس بالنتائج الشرعية لبعض أشكال الفساد الخلقي كالبغاء. وفي المقابل فإنّ ما تفرضه الأخلاق قد لا يُرتّب جزاءات قانونية بالضرورة (رعاية الأب لأطفاله مثلاً)، أمّا أسباب هذا التعارض فهي متعددة ومختلفة بنظر لويد، ففي حالات كثيرة لا يكون السلوك الخلقي الأسمى متجسداً بما فيه الكفاية في الشعور العام بحيث يُنتِج عملاً شرعياً يتّفق ويتلاءم معه. وقد يعكس القانون قواعد أخلاقية عامّة، وإن كان يتمّ إخضاع هذه الأخيرة ببطء لأسلوب أكثر صفاء وإنسانية. من الأمثلة التي يَسُوقها الكاتب لمناقشة كيف أنّ القانون يمتنع أحياناً عن التدخل في بعض الأمور الأخلاقية تحسباً من أن ينجم عن هذا التدخل نتائج أخطر من تلك التي جاء القانون لمعالجتها، مسألة تجريم السُّكر في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي التي منعت شُرب الخمر لكنّ النتائج كانت عكسية (كان هذا المنع موجوداً في زمن الكاتب لكنه اليوم لم يعد وارداً، كما أنّ تجريم المثلية الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد موجوداً منذ سنة 1957، بعد أن برهنت لجنة “ولفندن” على أنّ نَصّ التجريم يصعبُ تطبيقه، وإذا ما تم تطبيقه فإنّ من المحتمل أن يَضرّ أكثر ممّا ينفع، إذ قد يُشجّع على شرور أخرى كالابتزاز)، وكان للفلسفة الاقتصادية دور في هذا الصدد، خاصة مع طرح “سيتوارت مل” بخصوص عدم التدخل، بمعنى أنّ على القانون ألا يتدخل في الأمور المتعلقة بالسلوك الأخلاقي الخاص أكثر ممّا هو لازم للحفاظ على النظام العام، بعبارة أخرى: هناك منطقة أخلاقية من الأفضل أن تُترَك لضمير الفرد.
عاد مؤلّف كتاب “فكرة القانون” إلى تاريخ الجدل الذي قام بين الفلاسفة والعلماء حول العلاقة بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي، ومن ثمّ استنتج أنّ التناقض الذي حصل بين الفلاسفة (لا سيما بين أفلاطون وتلميذه أرسطو) قد أرخى بظلاله على فكرة القانون حتى يومنا هذا. ففكرة القانون الطبيعي تسلك سبيلين متعارضين حيال الطبيعة بما هي مفهوم، فمن جهة يُمكن اعتبار الطبيعة تعبيراً مثالياً لتطلّع الإنسان الأساسي حين تتحقق كافة طاقاته الكامنة، ومن جهة أخرى يمكن اعتبار الطبيعة أنها السبيل الذي يسلكه الإنسان بفعل تكوينه النفسي ـ الفيزيائي، وطبقاً للمفهوم الأول تكون الطبيعة مقياساً مثالياً تقاس به الأمور غير الطبيعيّة أو التقليدية الصرفة، أمّا طبقاً للمفهوم الثاني فتكون الطبيعة أمراً واقعياً حقيقيّاً لأنها تَدرس الإنسان كما هو وليس كما ينبغي له أن يكون. ومع ذلك فإنّ “لويد” لا يُنكر أنّ المفهوم الثاني يَشمل ضمناً عنصراً معيارياً، مادام لا بدّ من مقياس لتقرير ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي بالنسبة للإنسان. ولهذا، ظلّ هناك خلاف كبير حول القائلين إنّ القانون يمكن أن يُستنبَط بالتعليل والإلهام والإدراك بالبديهة، وبين المعالجة التي ترى أنّ خير برهان على ما هو طبيعي لحكم الإنسان في المجتمع هو القوانين والمقاييس التي تعتبر عامة للجنس البشري عموماً. (ص 71)
لم يكن التمييز الحاصل اليوم بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي وليد تأملات العلماء المعاصرين، بل إنّ كِتاب “فكرة القانون” يستعرض سلسلة من السجالات التي دارت حول هذه المسألة، لا سيما ما طرحته الفلسفة الرواقية، وتفاعلات المسيحية الكاثوليكة فيما بعد، والإسهام الكبير الذي قدمه اللاهوتي طوماس الأكويني وتلامذته للمسألة عندما استعادوا أفكار أرسطو ووطّنوها ضمن البيئة المسيحية النازعة نحو الانغلاق. وسيتطور هذا المسعى أكثر مع ظهور فكرة الحقوق الطبيعية التي جاءت مع بعض المصلحين والفلاسفة أمثال مارسيليوس وجون لوك، وذلك بالتوفيق بين القانون الطبيعي الذي يَفرض الطاعة والخضوع وبين الحقوق الطبيعية التي تجعل مبدأ الطاعة مقروناً باحتياز الشرعية، ومن هنا أصبح القانون الطبيعي يفرض الواجبات كما يَحفظ الحقوق، وكانت هذه الفلسفة فاعلة بشكل كبير خلال الثورة الأمريكية المتأثرة بأفكار جون لوك. كما جاء التأثير الأهم للحقوق الطبيعية مع الطرح الذي جاء به “روسو”، الذي انتصر فيها لفكرة “الإرادة العامة”.
يتضمن الفصل الرابع من الكتاب حواراً عميقاً بين أقطاب المدرسة الوضعية، فالنظر إلى القانون الوضعي على أنه يَشترك مع الأخلاق في كونه مِعيارياً من حيث أنّه يضع قواعد للسلوك أكثر ممّا يُعنى بذكر وقائع حسب وِجهة نظر دافيد هيوم، يقوم على التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وهو ما حمل في ثناياه، حسب لويد، توريطات خطيرة لفكرة القانون الطبيعي، فلئن اقترحت المدرسة الوضعية بعض الأفكار التي بموجبها وقع إيضاح كيف أنّ العواطف يمكنها خلق معايير أخلاقية من دون الحاجة إلى القانون الطبيعي، فإنّ السؤال يظلّ قائماً حول ما إذا كان ممكناً إيجاد معيار عقليّ يزوّد الإنسان بوسائل الحكم على ما هو صواب أو خطأ. وهو الإشكال الذي حاول “كانط” أن يُقدّم بخصوصه إجابة لـ”هيوم” بإقراره بوجود عالَمين: عالم ما هو كائن، وعالم ما ينبغي أن يكون، بحيث يتضمن العالم الثاني ما يسميه كانط الأوامر المطلقة وأحكام الأخلاق. وإن كان لويد يرى أنّ المُقترَح الكانطي لم يزودنا بمعيار فعّال لحل واقٍ لبعض المشاكل الهامة، وهو ما سرّع بظهور المذهب النفعي مع مُؤسّسه “جيرمي بنتام”، وبفضل سيادة هذا المذهب في القرن الثامن عشر نضج القانون الوضعي وذلك بإدخال عنصرَي اللذة والألم المرتبطين بالقانون، دون أن يعني ذلك أنّ المدرسة النفعية تجعل القانون والأخلاق متغايرين، فبنتام نفسه سخّر فكره لانتقاد القانون البريطاني، ورفض الطرح الهوبزي الذي يرى في كل ما ينص عليه القانون أخلاقياً بصرف النظر عن كونه جيداً أو سيئاً. إذ ترى النفعية أنّ الحُكم على جودة القانون من عدمها هو من اختصاص مبدأ النفعية العظيم الذي نادى به “بنتام” ورفاقه.
لكنّ المقاربات التي طورها علم الاجتماع تنتقد الوضعية لكونها تُميّز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، مُعتبرة أنّ القانون جامد لا يتحرك، بينما تفيد البحوث السوسيولوجية عكس ذلك، لا سيما أنّ الكثير من القواعد القانونية يتمّ تطويرها على يد القضاة الذين يتفاعلون مع مجتمعاتهم. كما ينتقد النظرية العلمية التي نادى بها “إيستون”، لأنّ الفقيه العلمي، حسب دينيس لويد، لا يستطيع تجاهل حقيقة كون القانون يحوي بذور تطوره وفق بعض القيم المقبولة في المجتمع، والطريقة التي تُوجّه فيها هذه القيم أو تَضبط القرارات القانونية المعقدة المتغيرة فتشكل العنصر الحيوي للنظام القانوني. لكنّ هذا لا يمكن أن يطعن في جميع الأحوال بشرعية الفكرة المحورية للوضعية القانونية بخصوص أنّ شرعية أي حكم قائم لا يُطعن فيها بوصفها التزاماً قانونياً، حين تَتعارض مع القيم الدينية أو الخلقية، أو أي مصدر غير قانوني (ص 103).
إنها لقضية هامة يَطرحها كتاب “فكرة القانون” حين يتناول إسهام القانون في تحقيق العدالة، فالقانون إذا لم يكن رديفاً للعدالة فهو سخرية حسب المؤلّف. فإذا كان “العدل أحد الأمور الخيّرة التي تسعى الأخلاق لتحقيقها للبشرية، فإنّ هذا الخير يعمل كوسيلة وكغاية في حد ذاتها”، وهذا ما جعل العديد من الفلاسفة ومنهم أفلاطون قد جعلوا العدل على قمة الأخلاق. وفي هذا السياق، يقيم الكاتب تمييزاً مهماً بين العدل الشكلي وتحقيق المساواة، فكون القانون يُطبّق بشكل مجرّد وعام على الجميع فهذا يَدخل في الجانب الشكلي للمساواة، وهذه صفة ضرورية لتحقيق العدل، وهو ما يعني أنه على جميع المتماثلين الخضوع للمعاملة نفسها. بمعنى آخر، فإنّ العدل الشكلي يتطلب المساواة في المعاملة وِفقاً للتّصنيف الذي أعده القانون. ولكنّ هذا لا يكفي من أجل تحقيق ما يسميه “لويد” العدل الموضوعي أو الجوهري، إذ ينبغي الجواب عن السؤال: كيف يتقرر أنّ القواعد القانونية هي ذاتها عادلة؟ فمثلاً يمكن أن يكون هناك نص قانوني يعطي للذكور حقّ التصويت بدون محاباة، ولكن حتى إذا تمّ تطبيق هذا النص بتجرد وعمومية فإنّه يظل غير عادلٍ، لأنه يَمنع فئة النساء من التصويت، ولهذا ينبغي البحث في عدالة القانون أولاً وبعد ذلك يتم التركيز على تطبيقه بشكل عام ومُجرّد، حتى لا يكون العدل في التطبيق يُخفي وراءه ظلماً في مُحتوى القانون.
هناك نقطة مهمة يسلط عليها الكاتب اهتمامه، وهي المتعلقة بمسألة “الضمير” الذي ينبغي أن يحكمه القاضي أثناء إصداره أحكامه، مما يطرح العديد من الأسئلة: هل على القاضي أن يُنفّذ جميع القوانين سواء أكانت جيدة أم سيئة؟ أم عليه أن يُحَكّم ضميره ولا يَحْكُم إلا بالقوانين الجيدة؟ وماذا لو تَعرّض للأذى إن هو رفض تنفيذ القانون؟ هل عليه أن يستقيل من منصبه حتى لا يطبّق قانوناً يراه جائراً؟ ألا يوجد هنا تعارض بين الواجب القانوني والواجب الأخلاقي؟ وهل يصنع القضاة القانون؟ وما العلاقة بين القضاء والسياسة؟
في سياق إجابته عن هذه الأسئلة، يسوق لويد العديد من التجارب والوقائع التاريخية، كما يستشهد برُزمة من الآراء الفقهية والفلسفية، كي يخلص إلى أنّ القانون وديعة في صدور القضاة، لكن هؤلاء ليسوا مستقبلين سلبيّين للقانون، بل يُثبِت التاريخ الحديث والمعاصر أنهم ساهموا بشكل كبير في صياغة قواعده، خاصّة في الدول التي يسودها القانون العام مثل بريطانيا والدول التي تأثرت بها. رغم أنّ سلطة القضاة على صنع القانون تختلف اختلافاً أساسياً عن وظيفة التشريع، ويُسلّط الكِتاب الضوء على مجموعة من الطُّرق التي يُساهم بها القضاة في صنع القوانين من قبيل: السوابق القضائية، والتفسير الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا، والترجيحات بين النصوص…إلخ.
ولكي تتوضح موسوعية إلمام الكاتب أكثر، وأهمية كتاب “فكرة القانون”، فإننا نرتئي اختتام هذه القراءة بإبراز إحدى أهم القضايا التي عالجها، وهي تلك التي تتصل بالعلاقة المتشابكة بين القانون والحريّة. أي كيف يمكن التوفيق بين الحريّة التي تأبى القسر، والقانون الذي لولا الإجبارية التي يتضمنها ما كانت لتكون له قيمة. فصرخة روسو حول: “أنّ الانسان ولد حراً لكن حيثما كان يرسف في الأغلال”، لا يمكن أن تكون إلا صرخة رومانسية حسب الكاتب، لأنها تَفترض أنّ المجتمعات البِدائية كانت مُتحرّرة من أية قيود قانونية، وهذا ما تخالفه القراءات الأنتروبولوجية التي أظهرت أنّ ثمّة قواعدَ اجتماعية التزم بها الإنسان البدائي الذي ابتكر أغرب العقوبات التي بموجبها تتمّ معاقبة مخالفي النظام العام، كما أنّ العصور السابقة بيّنت أنه عندما يسود التمييز وليس المساواة، لن يكون للحرية دور ضئيل يتمثل في حريّة الإنسان في الأمن والبقاء على قيد الحياة. وأمّا في عصرنا هذا، فدينيس لويد يرى أنّ فكرة الحريّة برمتها قد احتلت موقع الصدارة. ومن هنا حصل التمييز بين الحريّة السلبية التي تُعنى بتنظيم المجتمع بحيث إنه على الرغم من الضوابط والقيود التي فرضت على نشاط الفرد لصالح المجتمع، فإنّ هناك مجالاً واسعاً للمبادرة الحرّة. في حين تقتضي الحريّة الإيجابية تغليب الطابع الروحي أو الفكري الذي يتضمن إعطاء الإنسان الحد الأقصى من أجل التعبير عن طاقاته بصفته إنساناً، وعلى القانون أن يهتم بالسلوك الخارجي لا بالحالة الداخلية للتطور الروحي للمواطن الذي يخضع للقانون. ومن هنا جاءت القيم التي تُعدّ كونية من قبيل: حرية التعاقد، والاعتقاد، والتملك، والتنقل، والتجمع، والعمل، والتعبير…
هناك العديد من القضايا التي ناقشها الكتاب وتحتاج لأن يتوقف عندها القارئ، لا سيما ما يتعلق بالقانون الدولي وما يطرحه من إشكاليات تتعلق بالسيادة، ومبدأ عدم التدخل، والعدالة الدولية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وقوانين التجارة الدولية. كما يستعرض الكتاب بعض التجارب المُقارَنة في سياق إبرازه دور العلوم الاجتماعية في التعامل مع القانون، ودور الأعراف والتقاليد في تطوير القانون أو الحد من تقدمه. إضافة إلى الاشتباك الحاصل بين اللغة والقانون، والأيديولوجيا والقانون.
وفي سبيل ختم هذه القراءة، يمكن القول إنّ كتاب “فكرة القانون” مُهِمٌ في أيامنا هذه، لا سيما في ظل النقاش المُحتدم حول العديد من القضايا المرتبِطة بموضوعه من قبيل قضايا: الدولة، والعدالة، والجهة المختصة بالتشريع، ومصادر القانون، ومضامينه، والسبل القمينة بمنح المشروعية للقانون حتى يتلقّفه المواطن بالطاعة، والملاءمة بين القوانين المحلية والقوانين الكونية، وكيفية التوفيق بين تطبيق القانون وتأمين الحريات العامة. كما يجدر التنويه إلى أنّ هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة الطبع والتوزيع نظراً لافتقاد المكتبات العربية لنسخ منه، ونظراً لأهميّته بالنسبة إلى دراسي القانون وممارسيه على حدٍّ سواء.

د.عبد الرحيم العلام
أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي، جامعة القاضي عياض، صدرت له مجموعة من الكتب، ونسّق عدة مؤلفات جماعية؛ نشر العديد من الدراسات العلمية في مجلات محكمة دولية ووطنية؛ كاتب رأي في الجرائد المغربية؛ عضو مؤسس بمركز تكامل للدراسات والأبحاث.
Dr. Abderrahim Elaalam, is a professor of Constitutional Law and Political Thought at Al Cadi Ayad University, Marrakech. He has released a plethora books and coordinated the issuance of many books. He has published many scientific studies in International and National indexed scientific journals. He is an opinion piece writer in Moroccan newspapers and a founding member of the Takamul Center for Studies and Research.