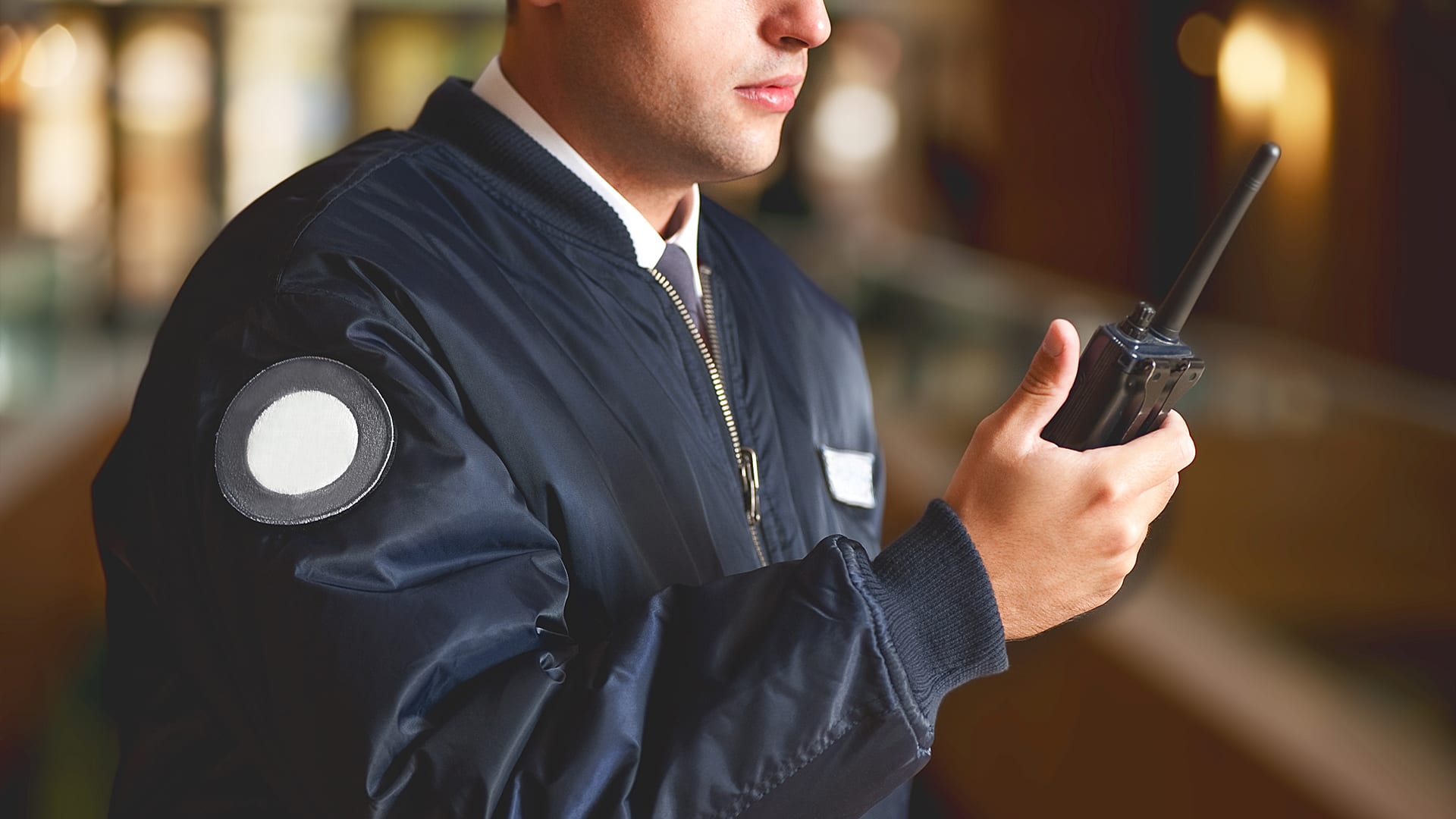إن القانون الصادر في 9 أغسطس/غشت بفرنسا الذي تم تقييده جزئيًا بموجب قانون 4 أبريل 1878، نص على أنه يمكن الإعلان عن حالة الاستثناء السياسية من قبل البرلمان أومن قبل رئيس الدولة في حالة وجود خطر وشيك يهدد الأمن الخارجي أو الداخلي. وقد لجأ نابليون الثالث عدة مرات إلى هذا القانون، وبمجرد تنصيبه في السلطة في يناير 1852، قام بنقل السلطة الحصرية لإعلان حالة الاستثناء إلى رئيس الدولة. تزامنت الحرب الفرنسية البروسية والتمرد الذي عرفته الكومونات مع تعميم غير مسبوق لحالة الاستثناء، التي أعلنت في أربعين مقاطعة واستمرت في بعضها حتى عام 1876. وعلى أساس هذه التجارب، وبعد الانقلاب الفاشل الذي قام به “ماكماهون” في أيار/مايو 1877، عُدِّل القانون سنة 1849 لينص على أنه لا يمكن إعلان حالة الاستثناء إلا بقانون وفي حالة لم يكن مجلس النواب منعقداً، يدعو رئيس الدولة البرلمان إلى عقد دورة في غضون يومين في حالة وقوع “خطر وشيك ناجم عن حرب أجنبية أو تمرد مسلح”(قانون 3 نيسان/أبريل) (قانون 3 نيسان/أبريل) ، 1878، المادة 1878. 1).
تزامنت الحرب العالمية الأولى مع حالة استثنائية دائمة في غالبية البلدان المتحاربة. ففي 2 أغسطس/غشت 1914، أصدر الرئيس الفرنسي “بوينكاريه” مرسومًا يضع البلاد بأكملها في حالة استثناء، وتم تحويل هذا المرسوم إلى قانون من قبل البرلمان بعد يومين. وظلت حالة الاستثناء سارية المفعول حتى 12 أكتوبر 1919. وعلى الرغم من أن نشاط البرلمان، الذي عُلِّق خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، استؤنف في كانون الثاني/يناير 1915، فإن العديد من القوانين التي صدرت كانت، في الحقيقة، تنازلا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، مثل قانون 10 شباط/فبراير 1918، الذي منح الحكومة سلطة مطلقة لتنظيم إنتاج المواد الغذائية والاتجار بها بموجب مرسوم. وكما لاحظ “تينستن”، فقد تحولت السلطة التنفيذية بهذه الطريقة إلى جهاز تشريعي بالمعنى المادي للمصطلح. على أي حال، خلال هذه الفترة أصبح التشريع الاستثنائي بموجب مرسوم تنفيذي ذو طبيعة حكومية والذي أصبح الآن مألوفا تماما بالنسبة لنا، وممارسة منتظمة في الديمقراطيات الأوروبية.
وكما هو متوقع، استمر توسع سلطات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومن المهم أن الطوارئ العسكرية قد تحولت إلى حالة الطوارئ الاقتصادية (مع استيعاب ضمني بين الحرب والاقتصاد). في يناير 1924، في وقت الأزمة الخطيرة التي تهدد استقرار عملة “الفرنك”، طلبت حكومة “بوينكاريه” صلاحيات كاملة على المسائل ذات الطبيعة المالية. وبعد نقاشات مستفيضة ومريرة اعتبرت المعارضة أن ذلك يعني تخلي البرلمان عن سلطاته الدستورية. فقد تم تمرير القانون في 22 مارس/آذار، مع تحديد صلاحيات الحكومة الخاصة بأربعة أشهر.وتم طرح تدابير مماثلة للتصويت في عام 1935 من قبل حكومة “لافال” ، التي أصدرت أكثر من خمسمائة مرسوم “بموجب قوة القانون ” من أجل تجنب تخفيض قيمة الفرنك. لقد عارضت المعارضة اليسارية، بقيادة ليون بلوم، بشدة هذه الممارسة “الفاشية” ولكن من المهم أنه بمجرد أن تولى اليسار السلطة مع الجبهة الشعبية، طلب من البرلمان في يونيو 1937 صلاحيات كاملة من أجل خفض قيمة الفرنك، وفرض السيطرة على الصرف، وفرض ضرائب جديدة.
وكما لوحظ، فإن هذا يعني أن الممارسة الجديدة للتشريع بموجب المرسوم التنفيذي من طرف الحكومة الذي بدأ العمل به خلال الحرب، أصبح الآن ممارسة مقبولة من جميع الأطراف السياسية. ففي 30 يونيو 1937، تم منح السلطات إلى حكومة Chautemps، حيث حصل “إدوارد داليلير” في 10 أبريل 1938 من البرلمان على صلاحيات استثنائية للتشريع بمرسوم من أجل التعامل مع كل من تهديد ألمانيا النازية والأزمة الاقتصادية. ولذلك يمكن القول إنه حتى نهاية الجمهورية الثالثة كانت الإجراءات العادية للديمقراطية البرلمانية معلقة.
عندما ندرس ولادة ما يسمى بالأنظمة الديكتاتورية في إيطاليا وألمانيا، من المهم ألا ننسى هذه العملية المتزامنة التي حولت الدساتير الديمقراطية بين الحربين العالميتين، وتحت ضغط نموذج حالة الاستثناء، بدأت الحياة السياسية الدستورية للمجتمعات الغربية بكاملها تتخذ تدريجياً شكلاً جديداً، ربما لم يصل حتى اليوم إلى تطوره الكامل. ففي دجنبر 1939، بعد اندلاع الحرب، حصلت حكومة “داليار” على سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الدفاع عن الأمة بموجب مرسوم. وظل البرلمان منعقداً بعدما عُلِّق لمدة شهر من أجل حرمان البرلمانيين الشيوعيين من حصانتهم، وكانت جميع الأنشطة التشريعية تقع بقوة في أيدي السلطة التنفيذية. وبتولي المارشال “بيتين” السلطة، كان البرلمان الفرنسي ظلاً لنفسه. ومع ذلك، فإن التعديل الدستوري الصادر في 11 يوليو 1940 منح رئيس الدولة سلطة إعلان حالة الاستثناء في جميع أنحاء الإقليم الوطني (الذي كان يحتله الجيش الألماني جزئياً في ذلك الوقت).
يتم تنظيم حالة الاستثناء في الدستور الحالي، بموجب المادة 16، التي اقترحها “ديغول”. وتنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة عندما تكون مؤسسات الجمهورية، واستقلال الأمة، وسلامة أراضيها، أو تنفيذ التزاماتها الدولية مهددة على محمل الجد وعلى الفور، ويتوقف العمل المنتظم للمؤسسات الدستورية.” ففي نيسان/أبريل 1961، خلال الأزمة الجزائرية، لجأ ديغول إلى المادة 16 على الرغم من أن أداء المؤسسات العمومية لم يتوقف. ومنذ ذلك الوقت، لم يتم الاحتجاج بالمادة 16 مرة أخرى، ولكن، وفقا للاتجاه المستمر في جميع الديمقراطيات الغربية، استعيض تدريجيا عن إعلان حالة الاستثناء بشكل معمم وغير مسبوق كنموذج للأمن وبوصفه الأسلوب العادي للحكم.
إن تاريخ المادة 48 من دستور “فايمار” منسوج بإحكام في تاريخ ألمانيا بين الحروب لدرجة أنه من المستحيل فهم وصول هتلر إلى السلطة دون تحليل استخدامات وإساءة استخدام هذه المادة أولاً في السنوات بين عامي 1919 و1933. وكانت سابقتها المباشرة هي المادة 68 من دستور “بسمارك”، التي منحت الإمبراطور، في الحالات التي تعرض فيها إلى التهديد للأمن العام في إقليم الرايخ،” سلطة إعلان حالة الحرب، التي اتبعت شروطها وقيودها الشروط المنصوص عليها في القانون البروسي الصادر في 4 يونيو 1851 التي تتعلق بحالة الاستثناء. ففي خضم الفوضى وأعمال الشغب التي أعقبت نهاية الحرب، صوت نواب الجمعية الوطنية على المادة 48 من الدستور الجديد التي تم بموجبها منح الرايخ سلطات طوارئ واسعة للغاية، وقد نصت على : “إذا كان الأمن والنظام العام مهدد فإن الرايخ الألماني، يجوز له اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والنظام العام، بمساعدة القوات المسلحة إذا لزم الأمر. ولهذه الغاية، يجوز له أن يعلق كلياً أو جزئياً الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و123 و124 و153.”
وأضافت المادة أن القانون سيحدد بالتفصيل الشروط والقيود التي يتعين بموجبها ممارسة هذه السلطة الرئاسية. وبما أن هذا القانون لم يصدر قط، فإن سلطات الرئيس الطارئة ظلت غير محددة إلى الحد الذي لم يستخدم فيه المنظرون بانتظام عبارة “ديكتاتورية رئاسية” في إشارة إلى المادة 48، في عام 1925، كتب المفكر القانوني “كارل شميت” أنه “لم يكن هناك دستور على وجه الأرض قد شرّع بسهولة انقلاباً كما فعل دستور فايمار. وباستثناء وقفة نسبية بين عامي 1925 و1929، استخدمت حكومات الجمهورية باستمرار المادة 48، فأعلنت حالة الاستثناء وأصدرت مراسيم طوارئ في أكثر من مائتين وخمسين مناسبة؛ من بين أمور أخرى، استخدموها لسجن الآلاف من المناضلين الشيوعيين وإنشاء محاكم خاصة خول إليها النطق بأحكام الإعدام.
إن حالة الاستثناء التي وجدت ألمانيا نفسها أمامها خلال رئاسة “هيندينبورغ” كان لها ما يبررها فقد اعتبر “كارل شميت” أن الرئيس تصرف كـ “حارس للدستور؛” ولكن نهاية جمهورية فايمار تثبت بوضوح أن “الديمقراطية المحمية” ليست ديمقراطية على الإطلاق، وأن نموذج الديكتاتورية الدستورية يعمل بدلاً من ذلك كمرحلة انتقالية تؤدي حتماً إلى إقامة نظام شمولي. وبالنظر إلى هذه السوابق، فإن دستور الجمهورية الاتحادية لم يذكر حالة الاستثناء. ومع ذلك، في 24 يونيو 1968، أقر “الائتلاف العظيم المشكل من “للديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين قانونًا لتعديل الدستور أعاد تقديم حالة الاستثناء التي تعرف باسم “حالة الضرورة الداخلية”،” ولأول مرة في تاريخ المؤسسة، تم الإعلان عن حالة الاستثناء ليس فقط لحماية النظام العام والأمن، ولكن للدفاع عن “الدستور الليبرالي الديمقراطي.” عند هذه النقطة، أصبحت الديمقراطية المحمية هي القاعدة.
في يوم 3 أغسطس/غشت 1914، منحت الجمعية الاتحادية السويسرية المجلس الاتحادي “سلطة غير محدودة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة وحياد سويسرا.” هذا العمل غير العادي – الذي بموجبه منحت دولة غير متحاربة صلاحيات للسلطة التنفيذية التي كانت أكثر اتساعا وغموضا من تلك التي تلقتها حكومات البلدان المشاركة مباشرة في الحرب – هو موضع اهتمام بسبب المناقشات التي أثارتها في الجمعية نفسها وفي المحكمة الاتحادية السويسرية عندما اعترض المواطنون واعتبروا أن القانون غير دستوري. لكن الفقهاء السويسريون عملوا على شرعنة حالة الاستثناء باعتبارها مسألة دستورية، خاصة المادة 2 التي تنص على ما يلي: “إن هدف الاتحاد هو ضمان استقلال الوطن ضد الأجنبي و الحفاظ على الهدوء الداخلي والنظام. من خلال هذا يتضح أن نظرية حالة الاستثناء ليست بأي حال من الأحوال سوى الإرث الحصري للتقليد المناهض للديمقراطية.
وفي إيطاليا، يكتسي تاريخ حالة الاستثناء وحالتها القانونية أهمية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الصادرة عن مراسيم الحكومة التابعة للسلطات التنفيذية الطارئة (ما يسمى بالمراسيم القانونية). وفي الواقع، يمكن للمرء أن يقول، من وجهة النظر هذه، إن إيطاليا تعمل كمختبر قانوني سياسي حقيقي وسليم لتنظيم العملية) التي تحول بموجبها المرسوم القانوني من أداة استثنائية للإنتاج المعياري إلى مصدر عادي لإنتاج القانون”. ولكن هذا يعني أيضاً أن إحدى النماذج الأساسية التي تتحول من خلالها عملية التشريع من البرلمان إلى الحكومة قد تم تفصيلها على وجه التحديد من قبل دولة كانت حكوماتها في كثير من الأحيان غير مستقرة. وعلى أي حال، فإن أهمية مرسوم الطوارئ في هذا السياق في المجال الإشكالي لحالة الاستثناء يُنظر إليه بوضوح.
لم يشر النظام الأساسي لألبرتين (مثل الدستور الجمهوري الحالي) إلى حالة الاستثناء. ومع ذلك، لجأت حكومات المملكة إلى إعلان حالة الحصار عدة مرات: في باليرمو والمقاطعات الصقلية في عامي 1862 و1866، وفي نابولي في عام 1862، وفي صقلية ولونجيانا في عام 1894، وفي نابولي وميلانو في عام 1898، حيث كان قمع الاضطرابات دموياً بشكل خاص وأثار مناقشات ساخنة في البرلمان. لقد كان الإعلان عن حالة الاستثناء بمناسبة زلزال “ميسينا” و”ريجيو كالابريا” في 28 ديسمبر 1908 مجرد حالة مختلفة على ما يبدو. لم يتم الإعلان عن حالة الاستثناء لأسباب تتعلق بالنظام العام أي لقمع عمليات السطو والنهب التي أثارتها الكارثة؛ ولكن كحالة فرضتها كارثة الزلزال، وهو ما عبروا عنه الحقوقيين الإيطاليين بأن الضرورة هي المصدر الرئيسي للقانون.
وفي كل حالة من هذه الحالات، أُعلنت حالة الحصار بموجب مرسوم ملكي، وإن كان لا يتطلب مصادقة البرلمان عليه، فقد وافق عليه البرلمان دائماً، وكذلك مراسيم الطوارئ الأخرى التي لا صلة لها بحالة الاستثناء (ففي عامي 1923 و1924، تم تحويل عدة آلاف من المراسيم القانونية المعلقة الصادرة في السنوات السابقة إلى قانون). وفي عام 1926، صدر قانون للنظام الفاشي ينظم صراحة مسألة المراسيم القانونية. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أنه عند تداول مجلس الوزراء، يمكن إصدار القواعد التي لها قوة القانون بموجب مرسوم ملكي . وعندما يتم التفويض للحكومة للقيام بذلك بموجب القانون، وفي الحالات الاستثنائية، التي تكون مطلوبة لأسباب الضرورة الملحة والمطلقة. ولا يخضع الحكم المتعلق بالضرورة والاستعجال لأي رقابة غير الرقابة السياسية للبرلمان.” كان لا بد من عرض المراسيم المنصوص عليها في البند الثاني على البرلمان لتحويلها إلى قانون؛ ولكن تعليق عمل البرلمان التام أثناء حكم النظام الفاشي جعل هذا الشرط غير ضروري.
على الرغم من أن الحكومات الفاشية كانت أساءت استخدام مراسيم الطوارئ بشكل كبير لدرجة أن النظام نفسه رأى في سنة 1939 أنه من الضروري الحد من انتشارها، فإن المادة 77 من الدستور الجمهوري أنشأت باستمرارية فريدة من نوعها يمكن للحكومة أن تتبنى في حالات استثنائية من الضرورة والطوارئ”، يمكن للحكومة أن تعتمد “تدابير مؤقتة لها قوة القانون،”والتي كان لا بد من تقديمها في نفس اليوم إلى البرلمان والتي خرجت عن الواقع إذا لم يتم تحويلها إلى قانون في غضون ستين يوما من صدورها.
ومن المعروف جيدا أنه منذ ذلك الحين أصبحت ممارسة التشريع من طرف الحكومة بموجب مراسيم قانونية هي القاعدة في إيطاليا. ولم تصدر مراسيم طارئة في لحظات الأزمة السياسية فحسب، مما يتحايل على المبدأ الدستوري القائل بأن حقوق المواطنين لا يمكن تقييدها إلا بموجب القانون (انظر، على سبيل المثال، المراسيم الصادرة لقمع الإرهاب: المرسوم القانوني الصادر في 28 آذار/مارس 1978، العدد 59، الذي تحول إلى قانون 21 أيار/مايو 1978، العدد 191 [ما يسمى بقانون مورو] ، والمرسوم القانوني الصادر في 15 ديسمبر 1979، رقم 625، المحول إلى قانون 6 فبراير 1980، رقم 15)، ولكن المراسيم القانونية تشكل الآن الشكل العادي للتشريع لدرجة أنها وصفت بأنها “مشاريع قوانين معززة بالطوارئ المضمونة.” وهذا يعني أن المبدأ الديمقراطي للفصل بين السلطات قد انهار اليوم وأن السلطة التنفيذية قد استوعبت في الواقع، جزئيا على الأقل، السلطة التشريعية. ولم يعد البرلمان الهيئة التشريعية ذات السيادة التي تتمتع بالسلطة الحصرية لإلزام المواطنين بموجب القانون: فهو يقتصر على التصديق على المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية. من الناحية التقنية، لم تعد الجمهورية الإيطالية برلمانية، بل تنفيذية حاكمة. ومن المهم أنه على الرغم من أن هذا التحول في النظام الدستوري (الذي يجري اليوم بدرجات متفاوتة في جميع الديمقراطيات الغربية) معروف تماماً لدى الفقهاء والسياسيين، إلا أنه ظل دون أن يلاحظه المواطنون على الإطلاق. في اللحظة التي ترغب فيها في إعطاء دروس في الديمقراطية لمختلف التقاليد والثقافات، لا تدرك الثقافة السياسية للغرب أنها فقدت نفسها بالكامل.
يعتبر المفهوم القانوني الوحيد في انكلترا المماثل لمفهوم حالة الاستثناء الفرنسية هو مصطلح الأحكام العرفية؛ ولكن هذا المفهوم غامض لدرجة أنه قد وصف بحق بأنه اسم سيئ الحظ لتبرير القانون العام للأفعال التي تقوم بها الضرورة للدفاع عن الكومنولث عندما تكون هناك حرب داخل المملكة.” هذا لا يعني أن شيئا مثل حالة الاستثناء لا يمكن أن يوجد. وفي قوانين التمرد، تقتصر سلطة التاج في إعلان الأحكام العرفية عموما على أوقات الحرب؛ ومع ذلك، فإنه ينطوي بالضرورة على عواقب وخيمة في بعض الأحيان بالنسبة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم متورطين فعليا في القمع المسلح. وهكذا سعى “كارل شميت” إلى التمييز بين الأحكام العرفية والمحاكم العسكرية والإجراءات الموجزة التي لا تنطبق في البداية إلا على الجنود، من أجل تصورها على أنها إجراء وقائعي بحت وتقريبها من حالة الاستثناء: “على الرغم من الاسم الذي تحمله، فإن الأحكام العرفية ليست حقا ولا قانوناً بهذا المعنى، بل هي إجراء يسترشد أساساً بضرورة تحقيق غاية معينة”.
لعبت الحرب العالمية الأولى دورا حاسما في تعميم الأجهزة التنفيذية الاستثنائية في انكلترا أيضا. وفي الواقع، وبعد إعلان الحرب مباشرة، طلبت الحكومة من البرلمان الموافقة على سلسلة من التدابير الطارئة التي أعدها الوزراء المعنيون، وتم تمريرها دون مناقشة تقريباً. وكان أهم هذه الأفعال قانون الدفاع عن المملكة في 4 أغسطس/غشت 1914، المعروف باسم DORA، الذي لم يمنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم اقتصاد زمن الحرب فحسب، بل نص أيضا على قيود خطيرة على الحقوق الأساسية للمواطنين (على وجه الخصوص، منح المحاكم العسكرية الولاية القضائية على المدنيين).
لقد شهد نشاط البرلمان خفوتا كبيرًا طوال مدة الحرب، تمامًا كما هو الحال في فرنسا.
إن المكان المنطقي والعملي لنظرية حالة الاستثناء في الدستور الأمريكي هو في الجدلية بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات الكونغرس. وقد تبلورت هذه الجدلية تاريخياً (وبطريقة مثالية بدأت بالفعل غداة الحرب الأهلية) كصراع على السلطة العليا في حالة الطوارئ؛ أو كصراع على القرار السيادي بتعبير” كرل شميت” لاسيما في بلد يعتبر نفسه مهد الديمقراطية. يكمن الأساس النصي للنزاع قبل كل شيء في المادة 1 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز تعليق امتياز أمر الحضور أمام المحكمة، إلا إذا كان في حالات التمرد أو الغزو التي تتطلب السلامة العامة ” ولكن لا يحدد السلطة التي لها اختصاص البت في التعليق. وتكمن نقطة الصراع الثانية في آخر المادة 1 التي تعلن أن سلطة إعلان الحرب ورفع ودعم الجيش والبحرية تقع على عاتق الكونغرس والمادة 2 التي تنص على أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى للجيش والبحرية في الولايات المتحدة.
ووصلت هاتان المشكلتان إلى ذروتهما الحرجة في الحرب الأهلية (1861-1865). عندما أصدر “لنكولن” مرسوماً يقضي برفع عدد الجيش إلى خمسة وسبعين ألف رجل وعقد جلسة استثنائية للكونغرس في 4 تموز/يوليوز. في الأسابيع العشرة التي مرت بين 15 أبريل و 4 يوليو، عمل لنكولن في الواقع كديكتاتور مطلق، لهذا السبب أشاراليه كارل شميت في كتابه الديكتاتورية كمثال مطلق على “الديكتاتورية التفويضية”. وفي 27 نيسان/أبريل سنة 1862، وفي قرار أكثر أهمية من الناحية التقنية أوذن للجنرال في الجيش بتعليق أمر الحضور أمام المحكمة كلما رأى ذلك ضرورياً على طول الخط العسكري بين واشنطن وفيلادلفيا، حيث وقعت اضطرابات. وعلاوة على ذلك، استمر الحكم المطلق للرئيس في اتخاذ قرار بشأن التدابير الاستثنائية حتى بعد انعقاد الكونغرس (وهكذا، في 14 فبراير 1862، فرض لينكولن الرقابة على البريد وأذان باعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في كونهم يقومون ب “ممارسات غير مخلصة وغير معقولة”).
وفى الخطاب الذي ألقاه أمام الكونجرس عندما انعقد يوم 4 يوليو1862، برر الرئيس علنا تصرفاته بأنه صاحب سلطة عليا لانتهاك الدستور في حالة الضرورة . “سواء كانت قانونية بحتة أم لا،” كما أعلن أن التدابير التي اعتمدها قد اتخذت “في إطار ما يبدو أنه مطلب شعبي وضرورة عامة” وله اليقين بأن الكونغرس سوف يصادق عليها. كما صرح أيضا حتى القانون الأساسي يمكن انتهاكه إذا كان وجود الاتحاد والنظام القضائي ذاته على المحك.
من الواضح أنه في حالة الحرب يكون الصراع بين الرئيس والكونغرس نظرياً في الأساس. والحقيقة هي أنه على الرغم من أن الكونغرس كان يدرك تمامًا أن السلطات القضائية الدستورية قد تم انتهاكها، إلا أنه لا يمكنه أن يفعل شيئًا سوى المصادقة على تصرفات الرئيس، وفي 22 سبتمبر 1862، أعلن الرئيس تحرير العبيد سيتم من حلال صلاحياته وحدها، وبعد يومين، تم تعميم حالة الاستثناء في جميع أنحاء أراضي الولايات المتحدة، وأوذن باعتقال ومحاكمة أمام المحاكم العسكرية جميع المتمردين والمحرضين داخل الولايات المتحدة، وجميع الأشخاص الذي يعملون على معارضة التجنيد الطوعي، ومقاومة الميليشيات، أو كل من يقوم بممارسة خائنة، وتقديم المساعدات والراحة للمتمردين ضد سلطة الولايات المتحدة.” عند هذه النقطة، كان رئيس الولايات المتحدة صاحب القرار السيادي بشأن حالة الاستثناء.
وفقا للمؤرخين الأميركيين، خلال الحرب العالمية الأولى تولى الرئيس وودرو ويلسون شخصيا صلاحيات أوسع من تلك التي ادعى ابراهام لينكولن. ومع ذلك، من الضروري تحديد أنه بدلاً من تجاهل الكونغرس، كما فعل لنكولن، فضل ويلسون في كل مرة أن يفوض الكونغرس السلطات المعنية إليه. وفي هذا الصدد، فإن ممارسته للحكم أقرب إلى الممارسة التي ستسود أوروبا في نفس السنوات، أو إلى الممارسة الحالية، التي تفضل بدلاً من إعلان حالة الاستثناء إصدار قوانين استثنائية. على أي حال، من عام 1917 إلى عام 1918، وافق الكونغرس على سلسلة من الأفعال (من قانون التجسس في يونيو 1917 إلى قانون Overman الصادر في مايو 1918) التي منحت الرئيس السيطرة الكاملة على إدارة البلاد ولم تحظر فقط الأنشطة الخائنة (مثل التعاون مع العدو ونشر التقارير الكاذبة)، بل جعلت من بعض الممارسات جريمة مثل طباعة أو كتابة أو نشر أي لغة غير مخلصة أو بذيئة أو مسيئة أو حول شكل حكومة الولايات المتحدة.
وقد وسع اندلاع الحرب العالمية الثانية هذه السلطات بإعلان حالة طوارئ وطنية في 8 سبتمبر 1939، والتي أصبحت غير محدودة في 27 مايو 1941. في 7 سبتمبر 1942، بينما طلب الرئيس من الكونغرس إلغاء قانون يتعلق بالمسائل الاقتصادية، جدد مطالبته بالسلطات السيادية خلال حالة الطوارئ: “في حالة فشل الكونغرس في التصرف بشكل ملائم، سأقبل المسؤولية، وسوف أتصرف…… الشعب الأمريكي يمكنه… تأكد من أنني لن أتردد في استخدام كل سلطة مخولة لي لتحقيق الهزيمة بأعدائنا في أي جزء من العالم حيث سلامتنا الخاصة تتطلب مثل هذه الهزيمة.” إن الانتهاك الأكثر إثارة للحقوق المدنية (الأكثر خطورة بسبب دوافعه العنصرية الوحيدة) حدث في 19 فبراير 1942، مع اعتقال سبعين ألف مواطن أمريكي من أصل ياباني يقيمون على الساحل الغربي.
الهوامش:
- النص الأصلي باللغة الانجليزية:
https://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/009254.html

محمد ضريف
حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من جامعة محمد الخامس، وكذلك درجة الإجازة في الدراسات الإنجليزية من جامعة ابن طفيل. قام الباحث بتأليف مقالات ودراسات حول قضايا تتعلق بالانتخابات والتحول الديمقراطي والحكامة المؤسسية.