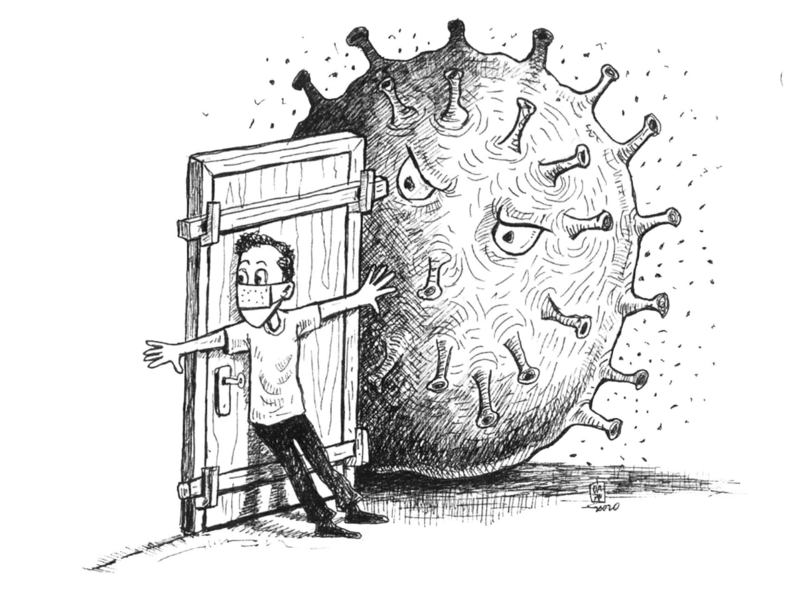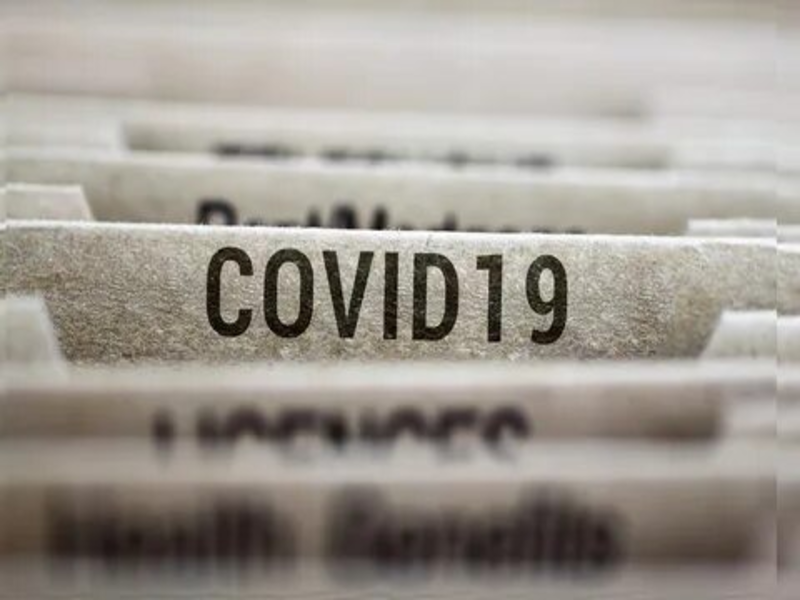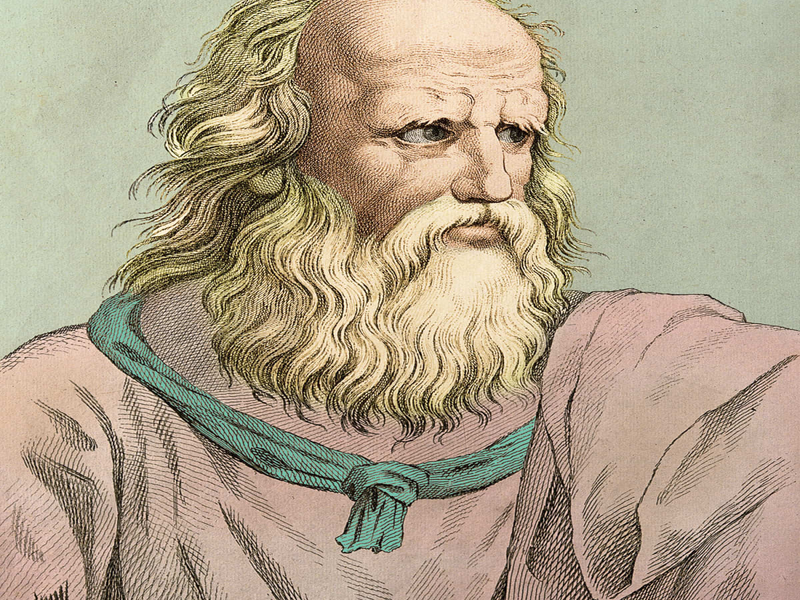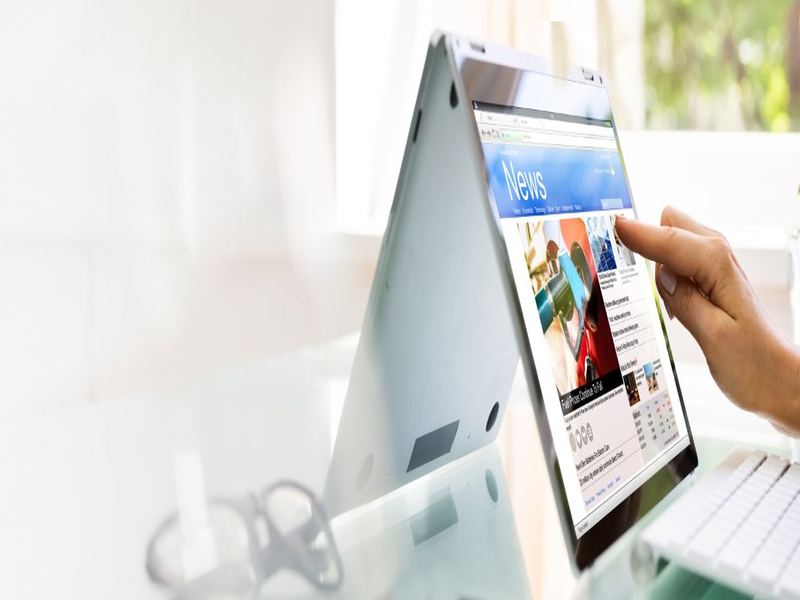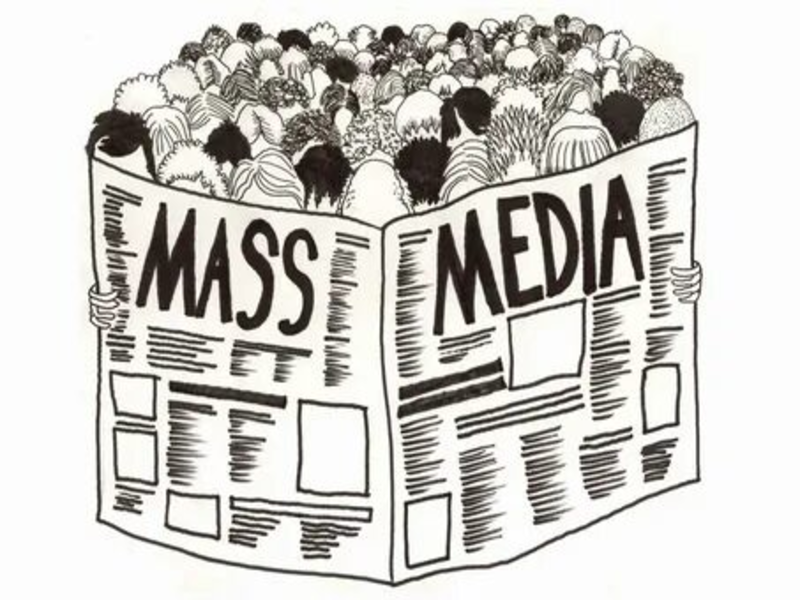وظائف الخطاب الصحافي الساخر في زمن الوباء
منذ ظهور وباء كورونا في المغرب، وما رافق هذا الوباء من أحداث ومستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية، شكلت موضوعا صحافيا دَسِماً لبث الخطاب الساخر، ونقد الظواهر المُدانة، التي نتجت عن حالة الطوارئ والحجر الصحي، والتي فرضتها جائحة كورونا؛ فاتخذ الكاتب الصحافي الساخر من السخرية جسرا تواصليا، و”جرعة طبية” لمواجهة الغضب واليأس والقلق والانفعالات السلبية، كما أنها وسيلة تواصلية وإعلامية، وأداة تعبير نقدي وإصلاحي. ويعد رشيد نيني من الكتاب الساخرين الذين ذاع صِيتُهم في السنوات الأخيرة، وتسعى هذه الدراسة إلى بحث الوظيفة الإصلاحية للسخرية، في مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في عمود “شُوفْ تْشُوفْ” لرشيد نيني، مركّزا على ما نشره خلال فترة الحجر الصحي فقط، ودراسة بعض الأساليب التي اعتمدها في سخريته الحاملة للوظيفة الإصلاحية، وكيفية تناولها من خلال الأحداث التي رافقت الجائحة، وبيان الموضوع الأهمّ في كتاباته الساخرة في مرحلة الوباء…