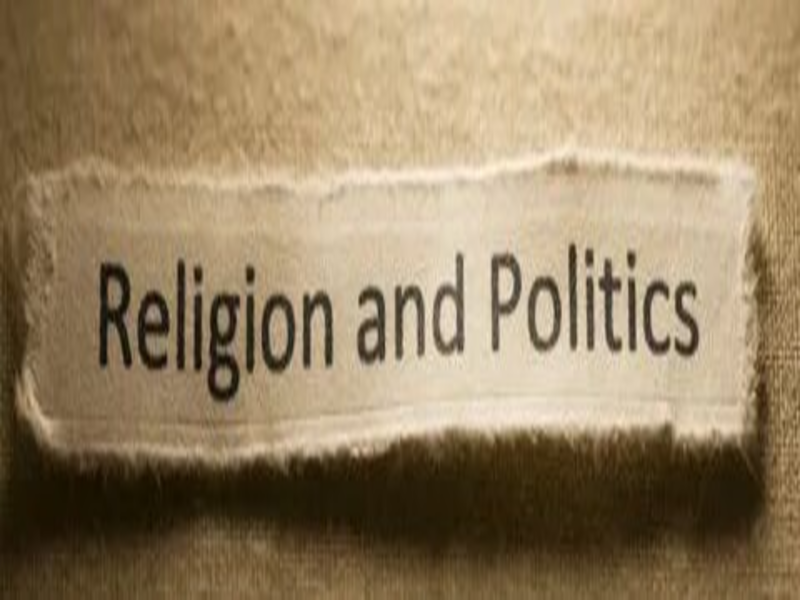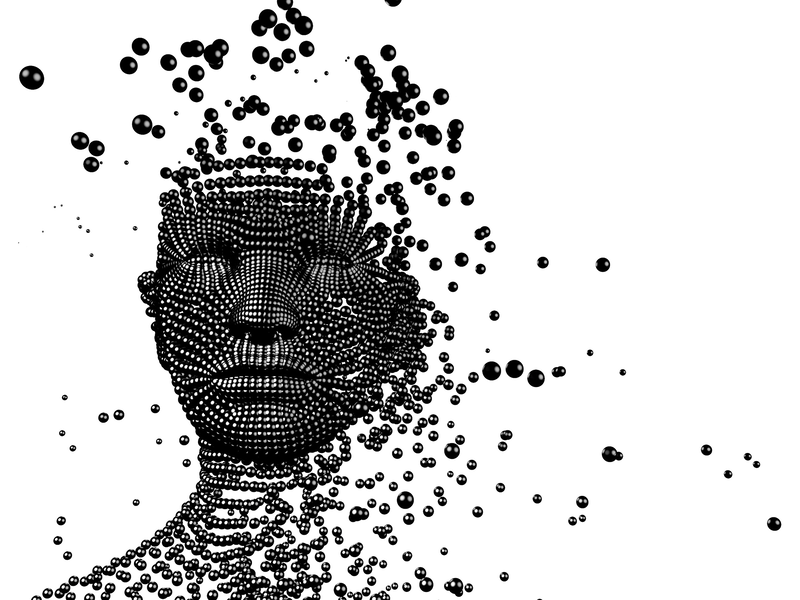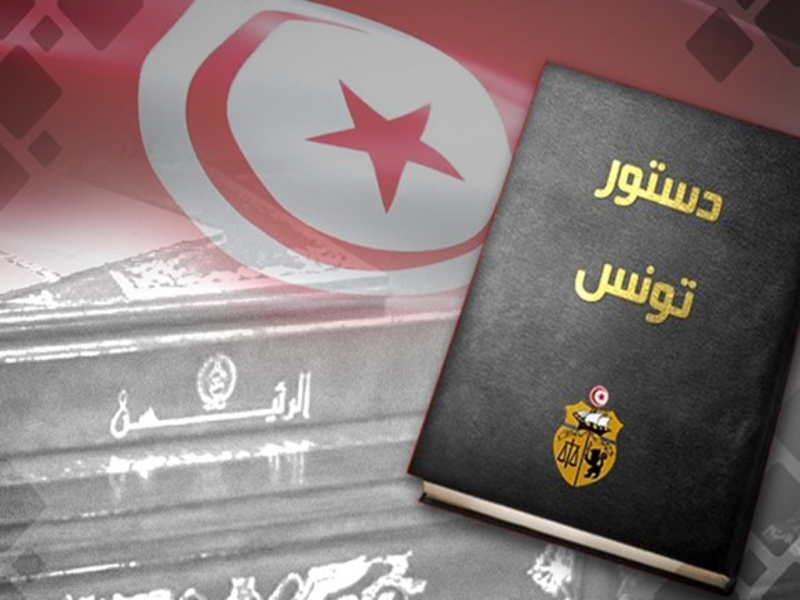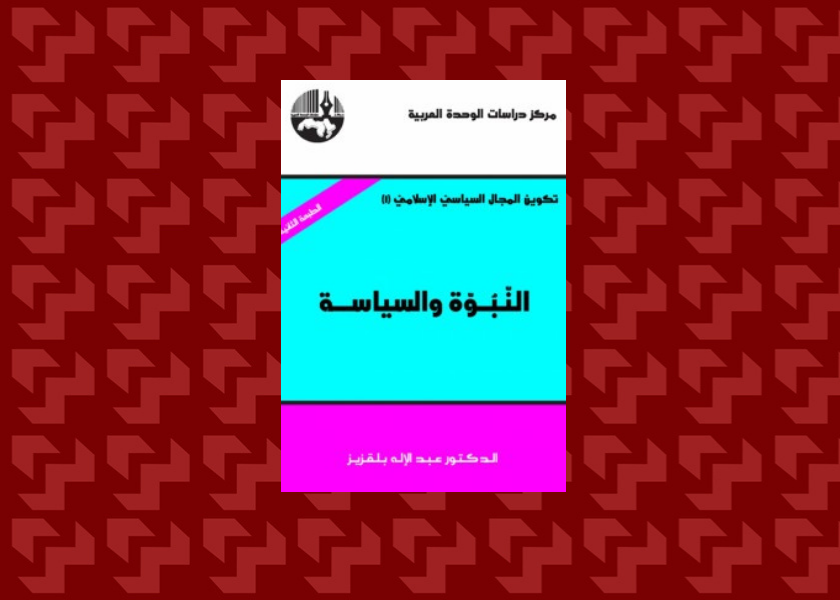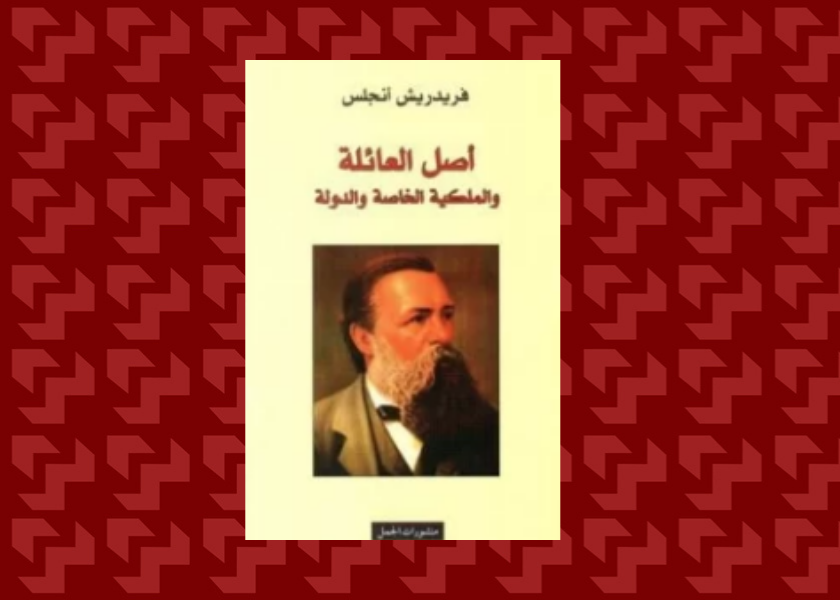سؤال الهوّية في علاقة السّياسيّ بالدّينيّ بالجزائر: قراءةٌ تفكيكيّةٌ في نسق العلاقة
يهدف هذا العمل إلى البحث في إشكالية العلاقة بين الدّينيّ والسّياسيّ وسؤال الهوّية بالجزائر، بمعنى أنّنا نتّجه إلى نوع من الموضعة لسؤال الهوّية بين هذين الحقلين المتجاذبين والمتجادلين في نفس الوقت. هذا التّجاذب والجدل تترجمهما علاقة قديمة ومستديمة بين الحقلين، فبناء نظرية السّلطة عمومًا لم يحد عن هذه القاعدة، سواء بإقصاء أحد الحقلين عن الآخر )فصل الدّين عن السّياسة ( مثلما جرى في أوروبا مع عصر الأنوار، أو من خلال دمج وأدلجة الدّينيّ بالسّياسيّ، كما هو حال عديد الدّول العربيّة والإسلاميّة، ومنها الجزائر؛وهذا باسم الهوّية والمرجعيّة. وإن كانت السّلطة السّياسيّة عندنا قد تبنّت منذ البداية (الاستقلال) خيارًا سياسيًّا وضعيًّا ودينيًّا يمارس فعل الوصاية على الدّين الإسلاميّ، ويشرف على ممارساته، وفق حقلنته ومأسسته، تحت وصاية وزارة تشرف عليه، وتحدّد ممارساته وفقًا لمرجعيّة سنّيّة مالكيّة.